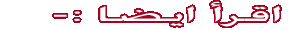إن الفتاة المتعلمة تود الانصهار في بوتقة كل ما هو جديد بكل شيء نابذة جهل النفس بالتقاليد والعادات القديمة، وطبعاً عندما تحاول الحصول على مبتغاها، ترى الاضطهاد من حولها، بكونها أنثى، ولا يحق لها أن تبلور ما بذاتها، إلى شيء نافع لها، وللمجتمع، فيكون الطوق المشدود من حولها، برباط وثيق، يشل تفكيرها، وحركة عقلها، على أن تكمل الدرب الذي رسمته، إلى جانب الفروق من أهلها، وبأنها دائماً الخاضعة لهم بكونها، أنثى، وليست رجلاً ذكراً، مما ولد عندها نوع من الغيرة، والحسد، إلى جانب الانفعالات، والاضطرابات الشديدة، مع حساسية زائدة في كل شيء، ولا تود أن تكون في عصر النهضة والعلم العالي، أدنى من الرجل، مهما كانت الظروف، لأنها توازيه من حيث الفكر والعقل، إلى جانب مختلف الوظائف، والمهن، وخاصة بعدما تفتح عقلها، وبعد أن قرأت، وتعلمت، وعلمت، إن الدين الإسلامي، هو أيضاً لا يفرق بين الأنثى والذكر، إلا بالتقوى. فكان هذا الشيء الذي بداخلها يستفزها، لأن تنطلق من القيود المفروضة، من رقابة الأهل، وضغوط الزوج، وفروق المجتمع المتناقض، والمساواة، بالحقوق والواجبات، جنباً إلى جنب مع الرجل.
ومن المؤكد أن العلم الذي توصلت إليه إمرأة اليوم وفتاته، أكسب كل فرد منهما، الثقة بالنفس، والاعتماد عليها، إلى جانب المسؤوليات الضخمة، دون مساعدة، كما كانت تفعل المرأة في الماضي، والذي يلزمها سلاح هذه المرأة العصرية، لتقاوم غائلة الدهر، وعوائقه الكثيرة، عن كونها الأدنى من الذكر أخوها، أو زوجها، حيث تساق كالبهيمة إلى مذبح الضحية، كيفما شاء هو، دون أن تنبث بأية كلمة.
هذه النماذج من النساء، أصبحت صوراً من الماضي العتيق، برأي إمرأة اليوم العصرية، التي تكافح، وتناضل، من أجل تحقيق غاياتها، وأهدافها، رغم كل الضغوط من حولها، ورغم المجتمع المتناقض، مرة مع تطورها صعداً نحو الأفضل، وطوراً ضدها، وعدم ارتفاعها كما ينبغي، من هنا شعرت المرأة في مجتمعات العالم الثالث، بقلة قدرها، وحطتها، إلى جانب خنوعها، وذلها، من جانب الأهل، والأسرة، والزوج، والمجتمع، مما ولد عند أكثر نساء اليوم، قيماً متناقضة بين القديم والجديد، وخاصة لدى النساء المتعلمات، اللواتي أصبح لهن، وعي جديد، ودور جديد، إلى جانب الدور القديم التقليدي الواقع على عاتقهن، من حيث ازدواجية المسؤولية، إلى جانب العمل الخارجي.
وباعتقادنا أن المجتمع إذا لم يتطور بكل أفراده، عصراً بعد عصر، وجيلاً بعد جيل، يظل التناقض والفروقات حاصلة بين كل الأطراف، من ذكر وأنثى إلى ما شاء الله.
وبما أن عصرنا، هو عصر العلم والمعرفة، وعند البعض عصر الجهل أيضاً، فيجب على كل فرد منا، أن يخوض غمار هذه الحياة، مع حفاظه على التقاليد، والعادات، والأخلاق الموروثة، إلى جانب الشرف والسمعة، لأنهم هم قيمة الفرد في الأسرة والمجتمع، لأن المجتمع الذي يجمع بين الجديد والقديم هو ينبوع القمة، لأن لو لم يوجد قديم، لما وجد وعرف الجديد؟! ولكن من المؤكد أن أكثر النساء في عالمنا المتحضر، لا يعرفن معنى ما أعنيه، فيكونون عرضة، دائماً بسبب توترهن، وانفعالاتهن، لى الصراعات النفسية، والأزمات العصبية.
وهذا ما نلاحظه في أكثر نساء جيلنا اللواتي ضعن بين المجتمع القديم وتقاليده، مع تطور المجتمع العصري بكل تناقضاته، حيث أن موقف المجتمع من المرأة، أشد قسوة بحقها من الرجل، وبطبيعة الحال، إن دور الرجل، ظل كما هو، من حيث معاملته القديمة للمرأة، ولم يتغير بتغير العصر، بل زاد في ميله، إلى فطرته الأولى، وهو نوع من السلطة، والأنانية الذكورية، إلى جانب الضغوط الذي يفرضها، كلما تطور العصر نحو الأفضل، كلما زادت الخلافات، والحدة بينه وبين زوجته ((ومع حدة الصراعات في حياة المرأة المتعلمة الواعية بحقوقها الجديدة أكثر من المرأة غير المتعلمة، غير الواعية بهذه الحقوق. وتزداد هذه الصراعات أيضاً في حياة المرأة المتعملة العاملة، لأن المجتمع لم يهيأ بعد إجتماعياً، وأخلاقياً، وتربوياً، ونفسياً، لدور المرأة المتعلمة العاملة.
ولا زال المجتمع بصفة عامة، ينظر إلى دور المرأة في البيت (كزوجة وأم) على أنه دورها الأساسي في الحياة، أو دورها الوحيد المسموح به، أو عملها خارج البيت، فليس إلا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل رب الأسرة في الحياة، وهو خدمة الزوج والأطفال في البيت)).
ومن الطبيعي أن جميع اللواتي يعملن موظفات في جميع الميادين، وكافة المهن، هن بالطباع منتجات بفاعلية حقيقية على كل الأصعدة، ولكن بنفس الوقت مستهلكات دون أن يدروا على كل الصُعُد، في العمل الإنتاجي، والعمل الخارجي والداخلي، وبسبب هذا الاستهلاك، مع فقدهن لقواهن النفسية، والجسدية، مما يزيد من إحساسهن، بالضعف والخذلان، أمام الانهيارات العصبية، الناتجة عن عدم الراحة لهن، على الصعيد العملي والمنزلي إلى جانب المسؤولية بتربية الأطفال، ورعايتهم، وإلى جانب المستلزمات بالبيت، الخاصة والعامة. وكأنهن آلة فقط للعمل الدائم ليلاً ونهاراً، لا وقت لإراحة أعصابهن، وأجسادهن، اللواتي هن بأمس الحاجة لها. ولكن للأسف بإمكاننا أن نقول أنهن مستهلكات فقط كالآلة، جسد دون روح.
لا أعني بقولي هذا إن البطالة كذلك مريحة، بل بالعكس، إنها تهد كيان الإنسان الخامل، والعاطل عن العمل، المنتج الفعال، إن كان على الصعيد العملي الخارجي، أو المنزلي، ولكن العمل هو الروح الحقيقية لمسيرة درب الإنسان، في سيره التصاعدي، نحو الأحسن والأكمل. ولكن بطريقة معقولة، تجاه الواقع والحقيقة، وتجاه الروح والجسد لا كالآلة تفعل ما يقال لها دون اعتراض؟
وبعض من النسوة مستريحات، حتى من التفكير الذي يعكر عليهن مزاجهن، ولا يحاولن أن يسألن أنفسهن لماذا؟ أو هل هذا؟ الخ. كل ما في الأمر أن هؤلاء النساء، اللواتي يعشن على حساب رب الأسرة، الذي يعمل لإسعادهن، ولو على حساب تعبه، وإرهاقه، وجسده، وحتى روحه، هؤلاء هن الطبقة البوروجوازية، اللواتي همهن السهرات، والحفلات والخ...؟ لا يعشرن بما تشعر به امرأة اليوم العاملة، والموظفة، من جهد في الحصول على لقمة العيش، من أجل الحياة القاسية ومتابعتها بدروب الحرمان والتعب؟! بل ينظرن، كنظرة الرجل الفوقية لمن هم دونهن؟!.
في الواقع والحقيقة، يوجد بعض من النسوة المتعلمات، الغير موظفات، يعملن فقط، في المنزل دون مشاركة رب الأسرة وصاحبها، لماذا؟ لأنهن لسن بحاجة إلى مزيد من الشقاء، والتعب فوق دورهن التقليدي في المنزل؟ إنهن فقط ((ربات بيوت)) و ((ستات صالون)) طالما أن الرجل يأتي امرأته بكل ما ترغب به، إذاً لماذا التعب؟ ولماذا إغراق هذا الجسد، في الأشغال ا لشاقة؟ ولم تفكر المرأة منهن، لو قدر الله، وفقدت مثلاً، المعيل، وهي التي لم تتعود النوع العملي المهني، ماذا يحل بها وبأطفالها؟!.
أعتقد لو فكرت لحاولت أن تفعل المستحيل حتى تؤقلم نفسها، في جو العمل المنتج الحقيقي. ولكن هذا النوع من النساء هو النوع الاستغلالي. وهذا النوع من النساء اللواتي يعتمدن على الغير، ولا يشعرن بأدنى مسؤولية تجاه الواقع والحقيقة. وبحيث أن البطالة النوعية تحرم المرأة من العمل الحر الذي يشعرها بأنها فرد منتج، كذلك يشعرها بأنها امرأة دونية لمن هو ربها ورب أسرتها؟!.
لأن الفرد المنتج في هذه الحياة، هو ضرورة ملحة وإنسانية، لتحقيق الذات، وسمو الكيان النفسي والروحي، إلى جانب سمو الرسالة الأولى، ألا وهي الأمومة. لأن العلم والعمل يكسبا امرأة اليوم نضجاً عقلياً، ونفعاً اجتماعياً، وسعادة وإشراقاً دائماً، إلى جانب ما تبلور من أفكارها مع تطور إنسانيتها، نحو حياة أفضل، مع جيل كله محب، كله قيم وأخلاق، كل فرد يقوم بما يسعد به الآخر، بما تفهمه من تجاربه، العلمية، والحياتية، لمعنى التطور. والازدهار العصري، وخلو النفس والعقل تماماً من الانفعالات النفسية، والأزمات العصبية، لأن الجهل بالأمور الحياتية النوعية يكسب المرء عكس ما يشتهي، وكما نلاحظه اليوم في عصرنا الحاضر، من فوضى أخلاقية، وجنسية، إلى جانب الآلام النفسية، والقتل، والسرقة.. الخ.
كل هذه الأمور الغير معقولة، تعود إلى السبب الحقيقي والأساسي، عدم التربية الصحيحة وعدم تطور أخلاق الفرد، في الأسرة، مع انبلاج العصر الحالي، إلى جانب الخلفية العقلية، الذي ورثها الخلف عن السلف الغير متطور، نفسياً وعقلياً وجسدياً إلى هكذا عصر؟! ويضعون اللوم على المجتمع، صحيح أن للمجتمع خلفياته التي لا تنكر، ولكن هذا المجتمع، من أين يأتي لكل فرد، ونفس خاملة بالحياة الحرة، إذا كان هذا الفرد الخامل العقل، لا يقدر أن يطور ما بداخل ذاته من خمول، ويكسبها قوة الإدراك والوعي التام؟!.. من هنا نعلم، لماذا انتشرت بين نساء جيلنا الأمراض النفسية، والأزمات العصبية، لأن التناقض مع الحياة، يكسب الفرد منهم، عقداً متنوعة كمرض ((العصاب)) المنتشر بكثرة بين الأطفال، والمراهقات، والنساء، والموظفات العاملات، وغير العاملات، وفي الشاب، والرجل الكهل.. وإلى غير ما هنالك، من أمراض وعقد كثيرة متنوعة.